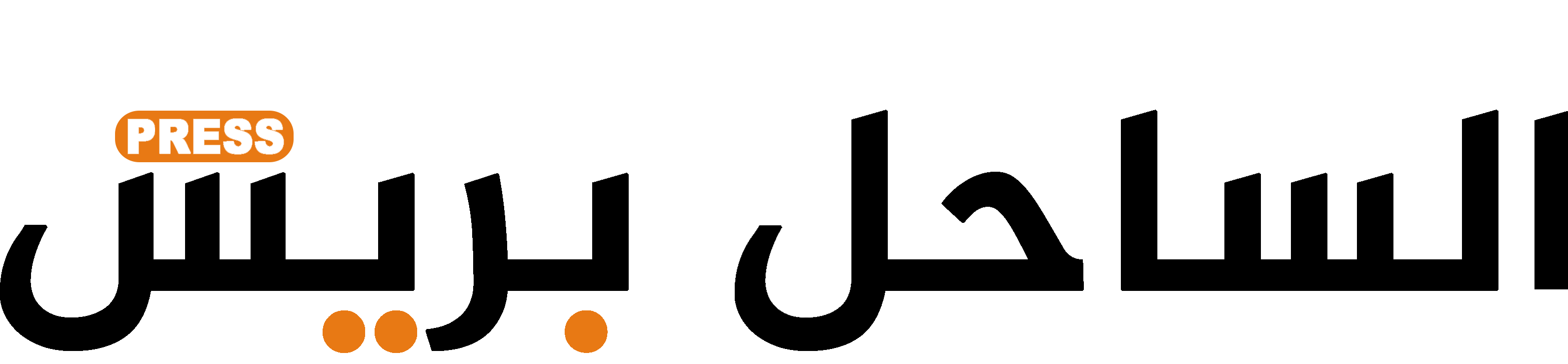بقلم : أحمدو بنمبا
تتنافس فرنسا مع روسيا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى على تثبيت نفوذها في القارة الإفريقية عسكريا واقتصاديا، سواء عبر تقديم خدمات أمنية لوقف تمدد الجماعات المسلحة، أو بإنشاء مشاريع بنية تحتية في دول تصنف على أنها فقيرة أو متواضعة اقتصاديا، كما تعتمد كثيرا على ما تناله من دعم في ظل التنافس الدولي على مقدراتها الطبيعية وطرق التجارة الإستراتيجية التي تتمتع بها.
وواجهت فرنسا، في السنوات الأخيرة، تحديات جمة في مناطق كانت لعقود من الزمن حكرا على استغلالها لتلك الموارد، إذ ظهر جليا بمرور السنوات أن باريس تخسر كثيرا من تلك المواقع مع تبدل السياسات واختلاف المحاور ومحاولة بعض الدول الإفريقية الاستقلال بقرارها الأمني والعسكري والاقتصادي بعيدا عن الهيمنة الأوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى جولته الإفريقية الثامنة عشرة شملت دولا عدة ، في إطار سعيه لإعادة إحياء علاقة باريس مع القارة الغنية بالموارد الطبيعية، وسط الحديث عن تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا، حيث يرى بعض الخبراء أن فرنسا غيرت أو حاولت، منذ دخول ماكرون قصر الإليزيه، شيئا من نهجها السياسي وعقيدتها العسكرية بتهيئة الظروف لانسحابها العسكري من بعض دول الساحل الإفريقي دون تحميلها المسؤولية عن الفوضى التي خلفتها سياسة السنوات الماضية، كما حدث فعلا بقرار إنهاء عملية “برخان” في منطقة الساحل بعد ثماني سنوات من الوجود العسكري الفرنسي في مالي.
فقد كانت تصفية الوجود الفرنسي نقطة مهمة تثير جدلا حزبيا فرنسيا قبيل الانتخابات الماضية التي فاز فيها الرئيس ماكرون بولاية جديدة، على أن هذا الانسحاب طوعا أو كرها ربما حاول تجنب مصير القوت الأمريكية وانسحابها من أفغانستان.
وبدى لافتا أن العام 2021 شهد تنافسا دوليا محموما لعقد اتفاقيات مع دول إفريقية، على رأسها صعود نفوذ روسيا بالمنطقة، مصحوبا بدور صيني خصوصا في منطقتي القرن والساحل الإفريقيين، دون إغفال الدور الأمريكي لأهمية إعادة التموضع هناك وفهم التقلبات الجيوسياسية التي باتت تحكم تلك الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، وسط تقلص الدور الفرنسي الذي أثر عليه ماضيه الاستعماري وتدخلاته السياسية والعسكرية بالمنطقة.
وبينما حظيت الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها الأزمة السورية وغيرها من الأزمات بتسليط الضوء عليها طيلة سنوات، فإن صراعا آخر حمل طابعا خفيا كان يدور في السنوات الأخيرة ضمن أتون الصراع على الثروات واستغلال الانقسامات المناطقية والعرقية والانقلابات التي تحفل بها القارة الإفريقية، فقد دفعت تقلبات أمنية وسياسية بدول إفريقية عدة للاستعانة بحلفاء جدد في ظل التنافس على ثروات إفريقيا، سواء النفطية والغازية أو مناجم الألماس والذهب واليورانيوم، فضلا عن الطرق التجارية والبحرية الجديدة.
وفي ظل التنافس المتنامي بين عواصم غربية وآسيوية للبحث عن موطئ قدم في إفريقيا، بدأت روسيا منذ حوالي 15 عاما في تنفيذ خطة حيازة النصيب الأوفر من المدخرات الإفريقية لصالحها، إلا أن الشراكة الاقتصادية الروسية الإفريقية لا تزال متواضعة وبنحو 20 مليار دولار.
وسعت قمة روسيا-إفريقيا التي عقدت في سوتشي عام 2019، إلى جعل الشراكة الثنائية نقطة انطلاق رسمية لمد نفوذ موسكو هناك وزيادة مشاريعها، وزادت في تعميقها عبر توفير مساعدات عسكرية وتدريب أمني وتوفير الحماية لبعض الأنظمة من خلال ميليشيات “فاغنر” العسكرية المثيرة للجدل، ومن خلال زيارة مسؤوليها للمنطقة، حيث قام سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي العام الجاري بزيارة عدة عواصم إفريقية لتعزيز علاقات بلاده مع تلك الدول.
وتعتمد الصين من جانبها، في مد نفوذها إفريقيا، بالدرجة الأولى على المساعدات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات الزراعية، حتى أصبحت الشريك التجاري الأكبر للقارة الإفريقية بنحو 200 مليار دولار، كما أن جزءا مهما من نشاطاتها الإفريقية يهدف لمحاولة عزل تايوان ووقف اعتراف بعض الدول الإفريقية باستقلالها، وذلك بعد إنشاء مشاريع كبيرة في إفريقيا بتنسيق أمريكي للضغط على بكين.
كما استغلت موسكو وبكين وأنقرة دبلوماسية اللقاح لمواجهة جائحة كورونا “كوفيد-19” على عكس الدول الغربية التي احتكرت اللقاحات، وحرمت منها دولا لم تستطع تحمل كلفتها المالية.
وبالتوازي مع ذلك، لم تبق الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، بل أقامت نشاطا اقتصاديا وعسكريا واسعا في دول إفريقية كثيرة بهدف التصدي للنفوذ الروسي والصيني في القارة، فضلا عن مواجهة ما تسميه “المد الإرهابي” في بعض الدول.
وإلى جانب ذلك، تنظم القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة إفريقيا المعروفة باسم “أفريكوم” تدريبات سنوية تضم قوات من عدة دول إفريقية وغيرها، وكان آخرها تدريبات “الأسد الإفريقي” العسكرية الدولية التي شارك فيها أكثر من 7500 عسكري من عدة دول في شهر يوليو الماضي. وزاد الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية في الآونة الأخيرة مع جولة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي التي شملت جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، وغالبا ما كان اهتمام الإدارة الأمريكية بإفريقيا لا يطغى على أولوياتها، لكنها تأمل في تغيير سياستها، ولذا تهدف لعقد قمة أمريكية إفريقية في الثالث عشر من ديسمبر المقبل في واشنطن.
ويؤكد تزايد النفور الإفريقي ضد التدخلات الغربية في شؤونها خلال السنوات الأخيرة، الرغبة الإفريقية في الاستقلال بالرأي، والاستفادة من الثروات المحلية، وسط قناعة بأن المطامع في خيرات القارة محل تنافس من القوى الاقتصادية الغربية والآسيوية، وهو أمر ألقى بظلاله على علاقة باريس بمستعمراتها السابقة التي تعالت أصواتها رفضا لأي تدخلات أو وصاية على قرارتها أو سيادتها.. فهل تنجح العواصم الإفريقية في رهانها على استغلال أهميتها الاقتصادية كورقة ضغط للحصول على نصيبها وحصتها من الناتج العالمي، أم أنها ستفاضل بين شركاء جدد، لا سيما في ظل بروز أزمات عالمية ومخاوف من ركود اقتصادي، وعدم وضوح الرؤى بخصوص مصير العديد من الملفات الدولية التي ستلقي بظلالها على مستقبل الوضع الدولي، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.