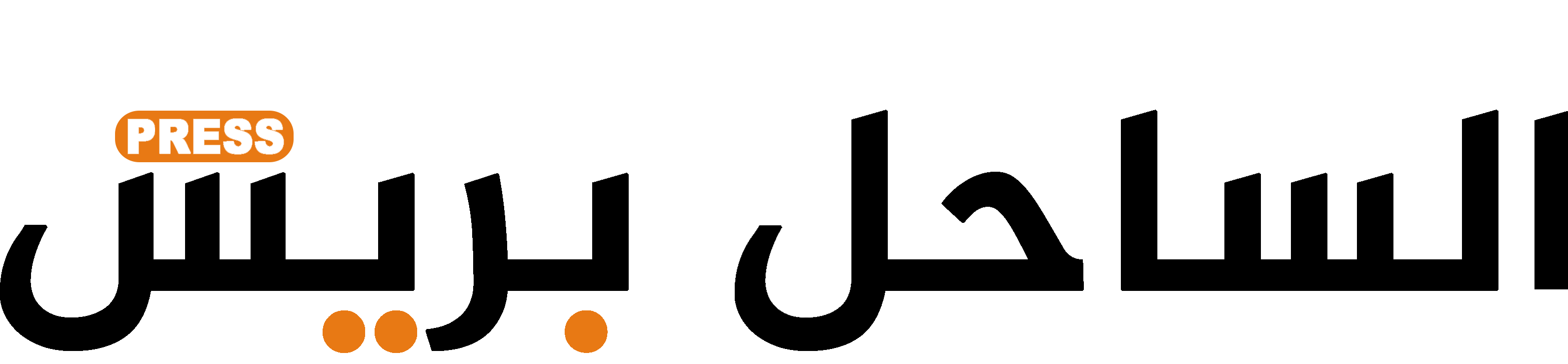بقلم : نجاة الراضي
ظلت علاقة الدين بالتنمية، محور نقاش علمي وفلسفي وسوسيولوجي امتد عبر حقب زمنية كبيرة وممتدة، ولم يتوقف هذا النقاش، لا عند المجتمعات الغربية ولا حتى عند المجتمعات العربية الإسلامية وإن كان بحدة أقل. فإذا كانت البوادر الأولى لهذا النقاش، قد حسمت في اتجاه إقامة قطيعة مع الدين ومع كل ما يتعلق بالميتافيزيقا والروحانيات، لأنّها تنتمي لعالم غير علمي وغير عقلاني، ولأنّها تصيب العقل بالعجز والفكر بالاتكالية والسلوك بالكلل. وهذا ما نجد تعبيره في أدبيات السوسيولوجيين الفرنسيين الأوائل تحديدًا (أوكست كونت وإميل دوركايم وسبنسر وغيرهم). فإنّه مع تطور الفكر السوسيولوجي، بدأت تبرز أولى الأعطاب حول هذا البراديغم السوسيولوجي – الذي يمكن وسمه باللائكي المتطرف -، على يد مؤسس سوسيولوجيا التدين والأديان (ماكس فيبر)، الذي بين من خلال مؤلفه (الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية)، بيّن أنّ الدين يمكن أن يلعب أدوارًا كبيرة في تحقيق التنمية والنهوض الحضاري. وقد اعتبر “فيبر” من خلال دراسته أنّ الدين لا يمكن النظر إليه باعتباره “ميتافيزيقا” أو أفكارًا تراثية ماضوية، أو حتى قوة محافظة (كما كان يدعي ذلك، الماركسيون)، بل أنّه عامل من عوامل التغيير، بدليل أن “فيبر” في تتبعه للفكر الديني البروتستانتي – تحديدًا -، وجد أن المذهبية البروتستانتية تدفع أتباعها، إلى حب العمل وإلى جمع الثورة وتحقيق النجاح الفردي، على عكس المذهبية الكاثوليكية التي تنحو نحو قيم المحافظة والاستكانة والقبول بالأمر الواقع.
لا نبالغ إذا قلنا بأنّ هذه المراجعة النقدية، في مجال الدين والتنمية، التي قام بها الفكر السوسيولوجي الغربي لمجموعة من مفاهيمه وبراديغماته ورؤاه، شكلت منطلقًا للعديد من الدراسات المقارنة في العالم، ففي بعض الدراسات التي حاولت أن تفهم كيف تحققت التنمية في بلدان آسيا (اليابان ماليزيا، سنغافورة الصين)، طرح السؤال: ما موقع الدين في العملية التنموية؟ وهل يمكن أن يشكل رافدًا من بين الروافد الأساسية لتحقيق التنمية؟
وهكذا، فقد توصل أحد الباحثين السوسيولوجيين (بنوي كومار ساكار)، وهو من أصل هندي، إلى أنّ هناك اختلافًا في النظر للدين ولأشكال التفاعل معه، بين المجتمع الصيني والمجتمع الهندي، فإذا كان الصينيون أمة عملية، تحركها قيم عملية ودونية محضة، حيث يتضخم الواجب نحو الفرد أكثر مما يتضخم الواجب اتجاه الرب. فإنّ الهنديين أمة خارقة في الروحانيات، إلى حد الهوس. ولهذا يحضر عندهم في تجربتهم الدينية التشوفات الأخروية وتحقيق الأجر الديني اللامادي، أكثر من تحقيق الفعل والعمل مع باقي أفراد المجتمع. إنّهم بكلمة “أمة تجد عبقريتها في ميتافيزيقيتها”.
وإذا أردنا أن نتأمل التجربة التنموية اليابانية والتي – شكلت مجالاً للعديد من الدراسات والأبحاث والكتب والملتقيات والمنتديات -، فإنّنا نجد أحد الأجوبة في الطريقة التي تفاعل بها اليابانيون مع الدين، إلى درجة أنّهم عرفوا بتقديسهم للعمل، باعتباره أمرًا إلهيًّا، فالإنسان متشبث بأرضه تشبت المتدين في العالم العربي بالصلاة. ولعل ذلك ما يحثنا على استكناه الأسباب العميقة وراء هذا التشبث؟ وفي بحثنا عن ذلك، نجد أنّ لذلك، أسبابًا دينيةً محضة، فالتمسك بالأرض، وحب العمل، إلى درجة التقديس، إنّما هو استجابة لأمر إلهي، ولأنّهم يبحثون عن الخلاص الفردي، كما يعتقدون في الأخلاق الكونفوشيوسية اليابانية.
وأثناء إجرائنا لبحث حول أسباب تراجع التعليم بالوطن العربي، ونجاحه في دول آسيا الجنونية، عثرنا على دراسة عالمية، أنجزها مركز الأبحاث (ماكنزي، 2007-2012)، تبين أنّ سر نجاح دولة (سنغافورة) في تحقيق نسب عالية في مردودها التعليمي، يعود إلى جودة المدرسين وإلى تشبعهم بالروح المهنية العالية، والتي أخذوها عن القيم الدينية الكنفوشيوسية، التي تحض على العمل والمثابرة والاجتهاد ونكران الذات.
من خلال ما سبق، يحق لنا التساؤل: إذا كانت التجارب الدينية السابقة – والتي لم نسق إلا أمثلة دالة عليها – قد بينت أنّها استطاعت أن تخلق علاقة تفاعلية جد خلاقة بين التنمية والدين أو التدين، فكيف هو الحال في التجربة العربية-الإسلامية؟ وهل يمكن الحديث عن تنمية مسنودة بخلفية دينية؟ أم على العكس من ذلك، فإنّ من عوائق التنمية في هذه البلدان الأخيرة، هو تمثلها للدين، ولطريقة تنزيله في أرض الواقع؟
في محاولة للإجابة على هذا الإشكال، نقدم نتائج بعض الدراسات العالمية المسحية، والتي اتخذت مقاربة مقارنة، حيث توصل الباحث “ستيفان فيش، في مؤلفه الرائع والذكي: (هل المسلمون مختلفون، Are Muslims Dstinctive، 2011 )، إلى أنّ مؤشرات الرشوة مرتفعة في العالم الإسلامي بنسبة 2.9، حسب المسح العالمي الذي تنجزه المنظمة العالمية للشفافية” وبعض المنظمات المدنية العاملة في مجال الرشوة، من خلال إحصائيين لسنتي2005/2007، بينما في الدول المسيحية حصلت على معدل(4.6) هذه النتيجة، ولو في حدود معينة، تبرز أنّ ظاهرة التوتر في الدين هي ظاهرة إسلامية محضة، إلى حد يمكن المجازفة بالقول إنّها خاصية مميزة للسلوك اليومي عند المسلمين، إذ في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات التدين في المجتمعات المسلمة (كالإقبال على الصلاة أو حضو
ر الصلوات في المساجد وفي أيام الجمعة وما إلى ذلك من مؤشرات ، فإنّه بالمقابل ترتفع مؤشرات الفساد بأبهى صورها، وربما الكل يعرف هذه الحقيقة، لكن عندما تكون دراسة علمية عالمية مقارنة ومثبتة بالأرقام والمعطيات وبالتحليل، تكون أكثر مصداقية وأكثر حجة من القول الشائع في الحس المشترك.
وفي بحثنا الميداني الذي كان حول “الشباب والممارسات والاتجاهات والقيم الدينية بمدينة سلا” (2013، غير منشور “جامعة محمد الخامس”، المغرب)، حول عينة تتألف من 450 شاب وشابة (تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة)، توصلنا إلى تسجيل ملاحظة جد هامة – الشباب يقبلون على قبول الغش في الامتحانات، وتقديم رشوة للإدارة المحلية للحصول على وثيقة إدارية…)، تصل إلى 40 بالمائة من العينة المستجوبة. مما يدل على وجود توتر صارخ في التجربة الدينية عند الشباب المغربي، والشباب العربي بشكل أكبر.
إنّ نتائج هذه الدراسات وغيرها، – وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يقال عنها، من ملاحظات منهجية وابستمولوجية وحدودها العلمية – فإنّها تكشف – ولو في حدود معينة – مدى تمثل القيم الدينية في المخيال ثم في الواقع. إذ كما هو معروف، فإنّ المجتمعات المسلمة، وعبر مؤسساتها الدينية التقليدية أو حتى الحديثة – ممثلة في حركات الإسلام السياسي – تركز أكثر ما تركز في خطابها وبرامجها وخططها وأهدافها وإعلامها، على الطقوس الدينية (كالحث على الصلاة في المسجد، والصيام، واللباس المتلحف بالرهبنة، وترك اللحى، والتشديد على لباس الحجاب…)، متناسية أهم قيمة في الدين وهي العمل والتفاني والاجتهاد وتعمير الأرض بالمنجزات، بدل تعميرها بالخرافة وبالتعلق بالرب بدون طائل وراءه. ولهذا تكثر الدعوات لتشييد المساجد أكثر ما تحضر الدعوة إلى بناء المدارس أو الجامعات أو بناء مراكز البحث ومستودعات التفكير. لأنّ الهاجس الأساس عند المسلمين، هو التقرب إلى الله، بالطقوس الدينية وليس بالأعمال الجليلة ومنها العلم والبحث الأكاديمي. ولهذا لا نستغرب إذا ما وجدنا مهندسين وأطباء وأساتذة جامعين، يفضلون حفظ القرآن في آخر مشوارهم الحياتي، بدل التعب من أجل البحث العلمي والاستمرار في الاكتشاف وسبر أغوار الكون العميق. إنّها أزمة فكر ورؤية وفهم للدين فيما نعتقد؟ وإلا لماذا لم نستطع لحد الآن أن نقدم الجواب عن إشكالية التخلف والتأخر، اللذين مازالا يضربان في أعماق كل المجتمعات العربية والإسلامية، ولا نذكر لهذه المجتمعات، سوى العنف والدمار والتخريب والتبعية، مرة باسم الدين ومرة باسم الاستبداد وأخرى باسم الاستعمار.
إنّنا نعتقد أنّه إذا كانت المراحل السابقة في تاريخنا الفكري، قد ركزت على محاولة البحث عن استنهاض الهمم ونفث تركة الماضي من الاستعمار وغيره، فإنّ المرحلة الحالية، – خصوصًا في ظل الحماسة الكبيرة للدين وللتدين ولأشكالهما – تحتاج – ليس إلى تجديد الخطاب الديني – وهو بدون شك مطلب حيوى وملح، ولكن بشكل أكثر منه، بل يفوقه ويضاهيه، هو مسألة تجديد علاقتها بالدين في اتجاه خلق تفاعل خلاق بينه وبين التنمية، وذلك بإقامة قطيعة نهائية مع كل القراءات والخطابات والبرامج والرؤى والمسلكيات التي تركز على ما هو طقوسي محض، متغافلة عن ما هو تنموي. إذ أنّ التنمية والدين وجهان لعملة واحدة، فلا تنمية بدون دين ولا دين بدون تنمية.