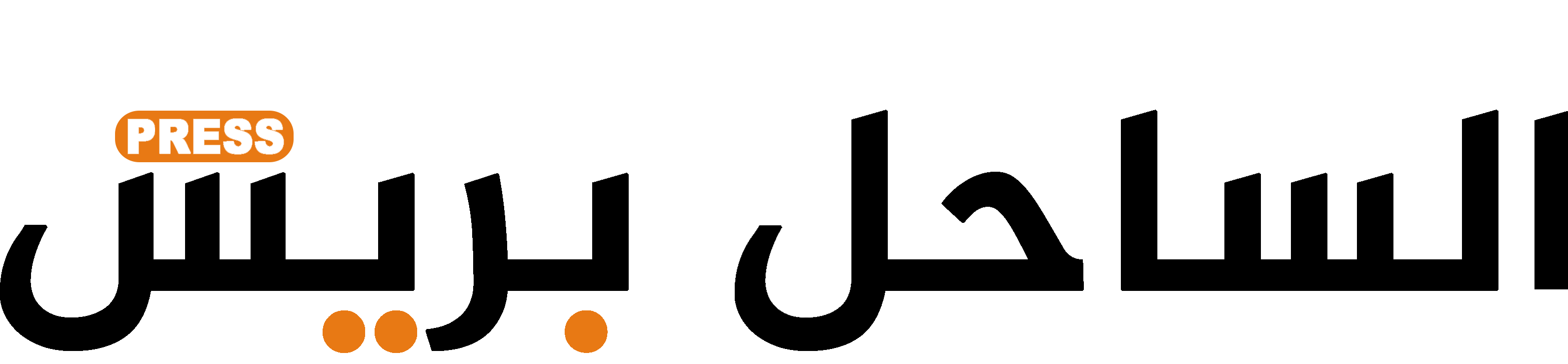بقلم : الصغير محمد
ليس ما يحدث في اللقاءات العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب مجرد تمرين كلامي، بل هو مسرح كامل تُعاد فيه كتابة الأدوار حسب تغيّر المصالح. الوجوه نفسها التي كانت قبل سنوات تبارك السياسات وتصفق للخيارات وتلتزم الصمت أمام الاحتجاجات، أصبحت اليوم تتحدث بلسان المظلوم، وكأن ذاكرة المجتمع صفحة بيضاء تُمسح بتغيير النبرة فقط.
يعرف الجميع أن كثيراً ممن يصرخون اليوم بالمعاناة كانوا، إلى وقت قريب، شركاء في إنتاج الواقع نفسه الذي يصفونه الآن بأنه ظالم. كانوا يوقّعون، يُصادقون، يبررون، ويُغلقون كل باب يمكن أن يدخل منه صوت المحتجين الحقيقيين. وعندما كان المعطلون يخرجون للشارع، لم يكن أحد منهم يجرؤ على الدفاع عنهم، بل كان الخطاب الجاهز يُلقى ببرود: “الدولة ما عندها شي”. فجأة، وبعد تغير موازين المصالح، صار للمعاناة موسم، وللشكوى قيمة، وللخطاب وظيفة.
المفارقة ليست سياسية فقط، بل أخلاقية أيضاً. فكيف لمن استفاد من منصبه، أو من التعيينات، أو من الدعم، أو من علاقاته داخل دوائر القرار، أن يتحدث اليوم عن الظلم وكأنه كان خارج اللعبة؟ كيف لمن جلس على مائدة المنتخبين، وبنى علاقاته في الظل، وتفاوض على مكاسبه الخاصة، أن يُقدِّم نفسه اليوم على أنه نصير “الناس البسطاء”؟ وكيف لمن كان جزءاً من كل قرار، أن يأتي اليوم بثوب الضحية ويطلب من الجمهور أن يصدّق قصته؟
إن هذا النوع من الخطاب يشبه — في بنيته العميقة — قصة “الدم الكاذب”: افتعال رواية لتبرير موقف لا يمكن الدفاع عنه. لكنه هذه المرة ليس موجهاً لأبٍ حزين، بل لمجتمع كامل يُفترض أن يبتلع التناقضات وينسى الوقائع.
غير أن المجتمع لم يعد كما كان. الناس، بفضل التجربة، أصبحوا قادرين على رؤية ما وراء الكلمات: من يتحدث؟ لماذا الآن؟ وماذا كان موقفه عندما كانت أصوات العاطلين ترتفع وتواجه العنف والتجاهل؟ هذه الأسئلة تكشف أن كثيراً من الخطابات الراهنة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، بل هي مجرد إعادة تموضع تكتيكي، محاولة للحفاظ على مكان في المشهد حين تتغير قواعد اللعبة.
ولذلك، فإن صوتاً واحداً فقط يستحق الإصغاء الحقيقي: صوت المعطل الذي قضى سنوات يجمع شهاداته ويبحث عن فرصة لا تأتي، رغم أن الجهة تعيش ثراءً كبيراً. هذا الصوت لم يشارك في أي قرار، ولم يدخل أي مكتب مسؤول، ولم يجلس على أي مائدة، ولم يتقاسم مع أحد مكاسب الريع. صوته حقيقي لأنه خالٍ من الحسابات، ولأنه لا يملك شيئاً ليدافع عنه سوى حقه في العيش.
ولا يمكن إصلاح هذا المشهد المقلوب إلا عبر خطوات واضحة. أولها كشف المصالح قبل كشف الأقوال. فلا معنى لخطاب سياسي أو مدني دون إعلان شفاف عن مصادر الدعم، المناصب، العلاقات، والامتيازات. بعد ذلك، تأتي المحاسبة: كل من تولى مسؤولية يجب أن يقدم جرداً صريحاً لما أنجزه وما أخفق فيه. لا يمكن السماح بتحويل الفشل الإداري إلى رأسمال رمزي يُستثمر لاحقاً في لعب دور الضحية.
ثم هناك ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات: التشغيل أولاً، عبر آليات شفافة ومستقلة. الاستثمار الحقيقي ثانياً، عبر محاربة الريع الذي التهم فرص الشباب. والتخطيط الجاد ثالثاً، بعيداً عن اللقاءات التي تُنتج الكثير من الصور والقليل من القرارات. وما لم تُمنح الكلمة للفاعل المدني المستقل عن مصالح السياسة والمال، فلن يتغير شيء، لأن من كان جزءاً من المشكلة لا يمكنه أن يكون صانعاً للحل.
إن ما يجري في الداخلة ليس حدثاً معزولاً، بل جزء من ظاهرة أوسع: حين تفشل النخب في الإنتاج، تنتج الكلام؛ وحين تخسر الامتيازات، تستدعي خطاب المعاناة؛ وحين تضيق مصالحها، تتسع لغتها. لكن الناس اليوم يرون ويسمعون ويقارنون. والصوت الوحيد الذي سيبقى هو الصوت الذي لا يخون التجربة المشتركة ولا يبيع الألم على موائد السياسة.