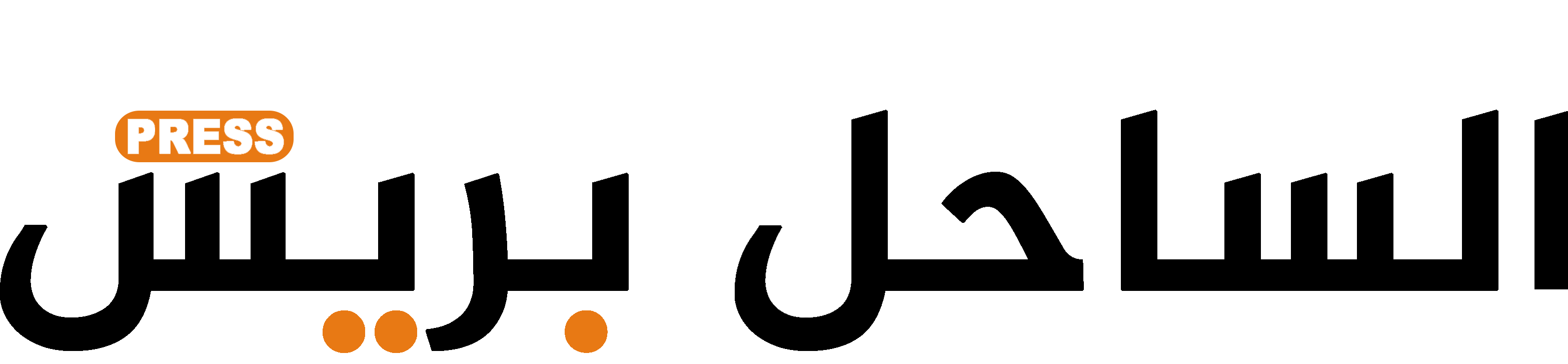بقلم : الصغير محمد
قد يبدو سؤال تجديد الثقة في المنتخبين سؤالًا مكررًا، يُطرح مع كل استحقاق انتخابي، ثم يُطوى كما طُويت أسئلة كثيرة قبله. لكنه في الحقيقة سؤال مؤجَّل أكثر مما هو مكرَّر؛ سؤال لم يُجب عنه بوضوح، لا من طرف المنتخبين ولا من طرف المؤسسات الوسيطة، وظلّ معلقًا بين صندوق الاقتراع وواقع الممارسة.
حين نعيد النظر في سنوات الانتداب الماضية، لا يمكن الاكتفاء بإحصاء ما تحقق أو ما تعثّر، لأن جوهر السؤال لا يتعلق فقط بالنتائج، بل بكيفية إدارة التفويض الشعبي. فالثقة السياسية، كما يذكّرنا ماكس فيبر، لا تقوم على الشرعية الإجرائية وحدها، بل على قدرة الفاعل السياسي على إقناع الناس بأن سلطته ذات معنى، وأن قراراته ليست مجرد امتثال للقواعد، بل تعبير عن رؤية ومسؤولية.
المفارقة أن جزءًا معتبرًا من الخطاب السياسي السائد اختزل العمل الانتخابي في لحظة الفوز، ثم تعامل مع ما بعدها باعتباره هامشًا تقنيًا محكومًا بإكراهات الآخرين. هكذا تحوّل المنتخب، في كثير من الحالات، من فاعل يفترض فيه المبادرة إلى متلقٍّ للقرارات، يبرّر أكثر مما يشرح، ويدافع أكثر مما يقترح. غير أن السياسة، في معناها العميق، لا تُقاس بقدرة الفاعل على التكيّف فقط، بل بقدرته على توسيع هامش الفعل داخل القيود، وهو ما عبّر عنه أنطونيو غرامشي حين ربط الفعل السياسي الحقيقي بالعمل داخل ميزان القوى لا بالاستسلام له.
ومن هنا، يصبح غياب أهداف واضحة للمرحلة المقبلة ليس مجرد نقص في التخطيط، بل خللًا في فهم الوظيفة التمثيلية نفسها. فحين لا تُحدَّد الأولويات بدقة، ولا تُربط الوعود بأفق زمني قابل للتقييم، يتحوّل الخطاب السياسي إلى مساحة رمادية تسمح بتأجيل المساءلة، وتغذية خطاب التبرير الدائم. والنتيجة أن المواطن لا يعرف هل يقيّم تجربة انتهت، أم ينتظر مشروعًا لم يبدأ بعد.
أما التواصل، الذي يُفترض أن يكون الجسر الطبيعي بين المنتخبين والناس، فقد عانى بدوره من اختزال مخلّ. بدل أن يكون ممارسة مستمرة، قائمة على الشرح والتفسير وإشراك الرأي العام في فهم الخيارات، صار في الغالب ردّ فعل ظرفيًا، يظهر عند الأزمات أو قرب المواعيد الانتخابية. هنا تتجلى إحدى أخطر مفارقات الديمقراطية التمثيلية التي نبّه إليها روبرت دال: حين يُختزل دور المواطن في التصويت، ويُستبعد من النقاش العمومي، تفقد التمثيلية معناها حتى وإن استمرت إجراءاتها الشكلية.
السؤال إذن ليس: هل أخطأ منتخبونا أم أصابوا؟ بل: هل قدّموا ما يكفي من وضوح، ومن قدرة على المبادرة، ومن استعداد للمساءلة، بما يسمح بتجديد الثقة على أسس جديدة؟ فالثقة لا تُستعاد بالخطابات العاطفية، ولا بتضخيم المنجز أو إنكار الإخفاق، بل بتسمية الأشياء بأسمائها، وبالانتقال من منطق الدفاع عن الحصيلة إلى منطق شرح الخيارات وتحمل تبعاتها.
لذلك، فإن الحاجة إلى تجديد الثقة، إن وُجدت، ليست حاجة تقنية ولا انتخابية فقط، بل حاجة سياسية وأخلاقية في آن واحد. حاجة إلى إعادة تعريف معنى الانتداب، وحدود التفويض، ومسؤولية القرار. لأن الثقة، في نهاية المطاف، لا تُمنح من جديد إلا حين يشعر الناس أن من انتخبوهم لا يتحدثون باسمهم فقط، بل يفكرون معهم، ويخطئون أمامهم، ويحاسَبون كما لو أن السياسة شأن عام لا امتياز خاص.