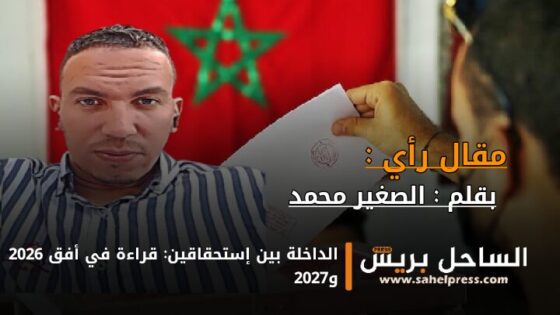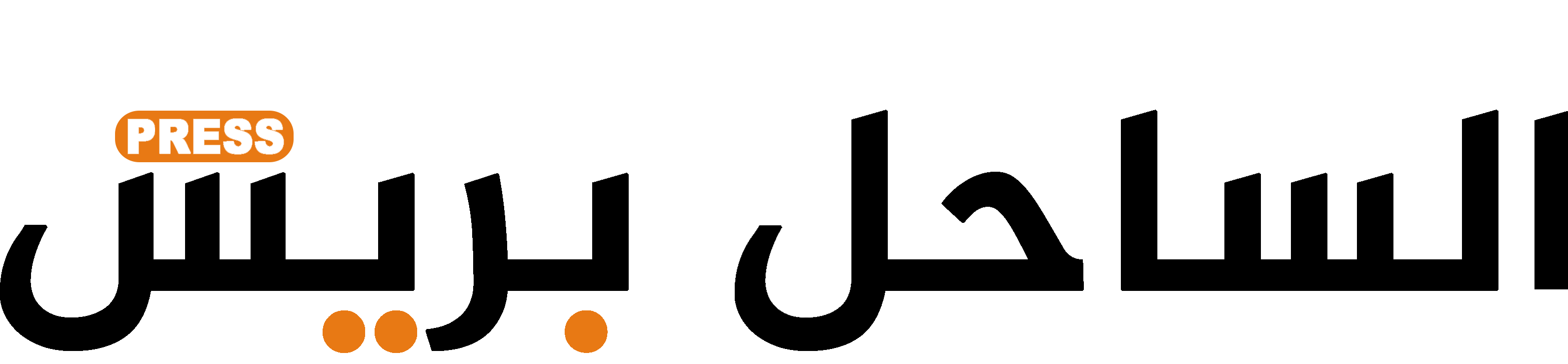تعيش الداخلة على وقع تحولات سياسية واجتماعية متسارعة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي ستتلوها بعد أقل من عام انتخابات جماعية وجهوية في 2027. لا يمكن فهم هذه المحطات بمعزل عن بعضها، فهما حلقات متداخلة في مسار ديمقراطي يراهن على الاستمرارية والتجديد في آنٍ واحد، حيث ينعكس أداء الفاعلين في مرحلة على نتائج وموازين القوى في المرحلة التي تليها، وخاصة في منطقة مثل الداخلة ذات الحساسية الجغرافية والرمزية والسياسية الخاصة.
بين استمرارية النفوذ وبوادر التغيير
على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الداخلة، يبقى المشهد السياسي فيها محافظًا إلى حد كبير على نمطه التقليدي، إذ ما تزال قوى النفوذ القبلية والاقتصادية تتحكم في آليات صنع القرار الانتخابي، مستندة إلى روابط اجتماعية عميقة وحسابات مصالح متشابكة. هذه القوى تستند إلى شبكات ولاء لا يقتصر تأثيرها على مجرد الانتخابات، بل تمتد لتشمل البناء الاجتماعي والسياسي بأسره.
لكن هذه الصورة ليست جامدة أو مطلقة، إذ بدأت معالم جديدة تظهر عبر دخول أجيال شابة، مثقفة ومتصلة بالعالم الرقمي، تنشد تغييرًا في الخطاب والممارسة السياسية. هذه الأجيال تعكس رغبة متزايدة في تحطيم التقاليد السياسية الراسخة، وترغب في تقديم بدائل تركز على الكفاءة، والشفافية، والقرب من هموم المواطن.
ومع ذلك، تبقى القدرة على تحويل هذه الحماسة إلى واقع انتخابي ملموس رهينة بعدة عوامل: قدرة هذه النخب على تشكيل تحالفات مؤثرة، قدرتها على اختراق قواعد النفوذ التقليدية، ومستوى وعي الناخبين وقدرتهم على تبني البدائل الجديدة.
انعكاس التشريعيات على الجماعية والجهوية
ستشكل انتخابات 2026 التشريعية اختبارًا مصيريًا في تقييم مدى قابلية المشهد السياسي للداخلة على التغير، وستكون مؤشراً واضحاً لمدى إقبال الناخبين على الوجوه الجديدة أو على استمرار الهيمنة التقليدية. إن تبلور نتائج غير تقليدية قد يفتح الباب واسعًا أمام إحداث تحولات ملموسة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستليها، خصوصًا وأن هذه الأخيرة تتميز بطابعها الأكثر قربًا للمواطن، وبتداخل أعمق بين السياسة والاحتياجات اليومية.
إلا أن طبيعة الانتخابات المحلية التي تعتمد على شبكة معقدة من المصالح الشخصية، العائلية، والقبلية، تجعل من احتمالية التغيير الجذري أمرًا أقل احتمالية، ما لم تترافق هذه الانتخابات مع وعي سياسي جماعي يسمح لكسر الحواجز التقليدية.
الشهادة الجامعية في المجالس الجماعية: شرط للتجديد أم عقبة أمام المشاركة؟
تطرح بعض الأصوات داخل الساحة السياسية فكرة ربط الترشح للمجالس الجماعية بشرط الحصول على شهادة جامعية، كآلية لتجديد النخب ورفع مستوى الأداء السياسي والإداري في تسيير الشأن المحلي. هذه المقاربة تحاول استثمار العنصر الأكاديمي لتعزيز جودة التمثيل وتمكين أشخاص يمتلكون خلفية معرفية تؤهلهم للتعامل مع تعقيدات الإدارة المحلية.
لكن هذا الشرط يثير جملة من التساؤلات: هل يمكن للشهادة الأكاديمية أن تحل مكان الخبرة الميدانية والمعرفة الاجتماعية العميقة التي يمتلكها بعض الفاعلين التقليديين؟ وهل لا يحرم هذا الشرط أعدادًا كبيرة من الفاعلين المحليين الذين يتوفرون على معرفة واسعة بمجتمعهم وقدرة على التواصل مع المواطن، رغم افتقارهم للشهادات؟
إن فرض هذا المعيار قد يؤدي إلى إقصاء فئات من المجتمع، وتحويل العملية السياسية إلى حكر على فئة أكاديمية محدودة، مما قد يزيد من الفجوة بين المواطن وممثليه، ويُضعف من جذرية المشاركة الشعبية. ومن ناحية أخرى، قد يعزز منطق الكفاءة ويرتقي بالعمل السياسي إلى مستوى أكثر احترافية ومسؤولية.
خاتمة : بين الحلم والواقع السياسي
في نهاية المطاف، لا يقاس مدى التغيير السياسي بعدد الوجوه الجديدة أو الشهادات التي يحملونها، بل بقدرتهم على إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتحويل المصلحة العامة إلى أولوية فوق حسابات المصالح الخاصة والضيقة. فإذا عادت الانتخابات لتنتج صورًا جديدة لنفس الأنماط القديمة، فسنكون أمام تجميل شكلي لا أكثر. أما إذا تمكّنت النخب الصاعدة من اختراق الحصون المنيعة للمصالح الراسخة، ونجحت في تحويل المشاركة السياسية إلى فعل اجتماعي يواكب تطلعات المواطنين، فحينها يمكن أن نعلن بداية فصل جديد من ديمقراطية الداخلة.
ويبقى السؤال قائمًا: هل نحن على أبواب انتخابات ستغيّر قواعد اللعبة، أم أنها مجرد نسخة أخرى من لعبة قديمة بقواعد جديدة؟